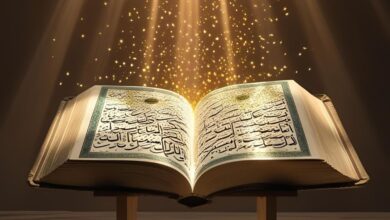أقوى أحداث السيرة! صلح الحديبية: القصة الكاملة بتفاصيل أول مرة تسمعها!

جدول المحتويات التفاعلي
- مقدمة: أهمية صلح الحديبية ولمحة عن المصدر
- التمهيد: قصة أبرهة والفيل – مقدمة إلهية
- الرؤيا النبوية والاستعداد للعمرة (أواخر شوال 6 هـ)
- الانطلاق نحو مكة: أحداث ومواقف في الطريق
- المواجهة الأولية والتفكير الاستراتيجي النبوي
- الوصول إلى الحديبية: معجزات وأحداث مفصلية
- سلسلة المفاوضات والرسل بين المسلمين وقريش
- بيعة الرضوان: عهد على الموت تحت الشجرة
- قدوم سهيل بن عمرو وشروط الصلح المجحفة
- أزمة أبي جندل بن سهيل: امتحان الصبر والإيمان
- ما بعد توقيع الصلح: غضب الصحابة وحكمة أم سلمة
- أحداث متفرقة بعد الصلح وقبل العودة
- العودة إلى المدينة وتنزّل سورة الفتح
- الدروس والعبر المستفادة من صلح الحديبية
- خاتمة: الحديبية فتح مبين وخطوة نحو النصر الأكبر
- رابط المصدر (الفيديو)
- الوصف التعريفي (Meta Description)
1. مقدمة: أهمية صلح الحديبية ولمحة عن المصدر
يُعد صلح الحديبية، الذي وقع في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، حدثاً محورياً وفارقاً في تاريخ الدعوة الإسلامية وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ورغم ما بدا في ظاهره من إجحاف بحق المسلمين وتنازلات قدموها، إلا أنه كان بحق “فتحاً مبيناً” كما وصفه القرآن الكريم، مهد الطريق لانتصارات إسلامية لاحقة، وعلى رأسها فتح مكة.
يقدم لنا “أنس أكشن” في مقطعه المطول على يوتيوب (من اقوى الاحداث في سيرة رسول الله!! | * صلح الحديبية * كاملة ( احداث اول مره تسمعها )) سرداً شيقاً ومفصلاً لأحداث هذه الواقعة، مبرزاً جوانب قد تكون غابت عن الكثيرين، ومعتمداً على البحث في بطون الكتب لاستخلاص التفاصيل الدقيقة. ويشير “أنس” في مقدمة الفيديو إلى الجهد الكبير الذي يبذله في إعداد محتواه من بحث وسرد وتصوير ومونتاج، وهو ما يعكس قيمة العمل المقدم. هذا المقال سيعتمد على هذا السرد الغني، مع إضافة التحليلات اللازمة لتسليط الضوء على الأبعاد المختلفة لهذا الحدث العظيم.
إن قصة صلح الحديبية ليست مجرد سرد تاريخي، بل هي مدرسة متكاملة في القيادة، والصبر، والثقة بالله، وفقه الواقع، والنظرة الاستراتيجية بعيدة المدى. وهي تعلمنا كيف يمكن أن تكون الهزيمة الظاهرية مقدمة لنصر حقيقي، وكيف أن طاعة الله ورسوله، حتى فيما قد يبدو مخالفاً للمنطق البشري المباشر، هي مفتاح الفلاح والنجاح.
2. التمهيد: قصة أبرهة والفيل – مقدمة إلهية
قبل الخوض في تفاصيل صلح الحديبية، يستعرض “أنس أكشن” قصة أبرهة الحبشي ومحاولته هدم الكعبة، وهي قصة تحمل دلالات عميقة وترتبط بشكل رمزي بأحداث الحديبية. كان أبرهة، حاكم اليمن، يغار من مكانة مكة وقصد الناس إليها للحج والعمرة، فبنى كنيسة عظيمة (القليس) ليصرف العرب عن الكعبة، وحين لم يفلح، قرر هدم الكعبة مستعيناً بجيش جرار وفيل ضخم.
عندما اقترب أبرهة من مكة، برك فيله ورفض التقدم نحو الكعبة رغم كل محاولاتهم، وكأنه يرى ما لا يرون. ثم أرسل الله عليهم طيراً أبابيل تحمل حجارة من سجيل، فأهلكت الجيش عن بكرة أبيه. هذه الحادثة، التي وقعت في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم (عام الفيل)، كانت إرهاصاً بمكانة هذا البيت وحمايته الإلهية.
الربط الذي يقيمه الراوي بين هذه القصة وأحداث الحديبية يكمن في توقف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم (القصواء) لاحقاً عند الحديبية، وقوله: “حبسها حابس الفيل”. هذا الربط يشير إلى أن الإرادة الإلهية هي التي تسير الأحداث، وأن ما قد يبدو عائقاً أو مصادفة، هو في حقيقته تدبير إلهي لحكمة لا يعلمها إلا الله. انظر القسم 6.1: “حبسها حابس الفيل”
3. الرؤيا النبوية والاستعداد للعمرة (أواخر شوال 6 هـ)
3.1. تفسير الرؤيا وبشرى الصحابة
في أواخر شهر شوال من السنة السادسة للهجرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا غريبة ومبشرة: أنه يدخل البيت الحرام هو وأصحابه آمنين، محلقين رؤوسهم ومقصرين، ويأخذ مفاتيح الكعبة، ويطوفون ويعرفون (يقفون بعرفة). ورؤيا الأنبياء حق، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عمرة قريبة.
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذه الرؤيا، فاستبشروا بها خيراً عظيماً. فاضت قلوبهم شوقاً إلى بيت الله الحرام الذي أُخرجوا منه قبل ست سنوات. وظن الكثير منهم أن هذه الرؤيا تعني فتح مكة بشكل كامل في تلك السنة، وأنهم سيعودون إلى ديارهم وأموالهم. هذا التوق العارم والشوق الجارف كانا المحرك الأساسي لخروجهم، رغم المخاطر الكبيرة التي كانت تكتنف هذه الرحلة. آخر عهدهم بقريش كان معارك دامية، آخرها الخندق، ولا يزال حقد قريش متأججاً على المسلمين بسبب قتلاهم في بدر وغيرها. فكرة الذهاب إلى عقر دارهم، غير مسلحين بنية القتال، كانت تبدو ضرباً من الجنون للبعض، ومغامرة محفوفة بالمخاطر. لكن ثقتهم في نبيهم وفي وعد الله كانت أقوى.
3.2. تجهيز الهدي وسنن الإحرام الفريدة
أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتجهز للعمرة، فلبى النداء حوالي 1400 صحابي (تختلف الروايات قليلاً في العدد)، من المهاجرين والأنصار، ومن بينهم كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. جمع النبي صلى الله عليه وسلم الهدي (الإبل التي ستُذبح كقربان في مكة)، وكان عددها سبعين بدنة، ومن بينها جمل أبي جهل الذي غنمه المسلمون في غزوة بدر، في إشارة رمزية قوية.
وفي ليلة من ليالي ذي القعدة، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ولبس ثوبي الإحرام (إزار ورداء أبيضين من نسج يمني)، لكنه لم ينوِ الإحرام من بيته، بل أرجأ النية إلى الميقات (ذي الحليفة لأهل المدينة). وهذا من السنن، حيث يجوز لبس ملابس الإحرام قبل الميقات، ولكن نية الدخول في النسك تكون عند الميقات.
3.2.1. الإشعار والتجليل والتقليد: تعظيم شعائر الله
عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى الميقات (ذي الحليفة، أبيار علي حالياً)، وبعد أن صلى الظهر، قام بسلسلة من الأفعال التي قد تبدو غريبة للبعض ولكنها سنن راسخة في تعظيم الهدي، وكما ذكر “أنس أكشن”، قد تكون هذه التفاصيل جديدة على الكثيرين:
- الإشعار: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تُجرح الإبل جرحاً خفيفاً بشفرة في صفحة سنامها الأيمن، ويُمسح الدم بسرعة، فتكون هذه علامة مميزة على أنها هدي مُعدٌّ للتقرب به إلى الله. هذه العلامة تجعلها معروفة ومحترمة.
- التجليل: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تُلبس الهدي (بعض الإبل) أغطية أو أقمشة وهي موجهة للقبلة، وهذا أيضاً من تعظيمها وإظهار أنها مخصصة لله.
- التقليد: وهو الأمر الأكثر إثارة للدهشة كما وصفه الراوي، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تُقلّد الإبل بالنعال. أي أن يُؤخذ نسيج من صوف أو غيره، وتُعلق فيه النعال القديمة، ثم يُعلق هذا النسيج في رقاب الإبل.
يشير “أنس أكشن” إلى أن هذه الممارسات، خاصة التقليد بالنعال، كانت معروفة عند العرب قديماً قبل الإسلام. والسبب في ذلك أن قطاع الطرق والسراق في الجزيرة العربية كانوا إذا رأوا إبلاً مُقلّدة بالنعال، عرفوا أنها متوجهة كقربان إلى بيت الله الحرام، فلا يتعرضون لها، حتى لو كانت تسير وحدها، وذلك تعظيماً منهم لشعائر الله، أو خشية من العواقب. وهذا يعكس مفارقة عجيبة أشار إليها الراوي، وهي أن “مشركي زمان كانوا يخافون الله أكثر من مشركي هذا الزمان، حتى السارق زمان كان يخاف من الله”. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الممارسات وتطبيقها جعلها سنة للمسلمين في الهدي.
بعد هذه الاستعدادات، أحرم النبي صلى الله عليه وسلم ونوى العمرة، وأحرم معه الصحابة، إلا قلة قليلة كانوا بمثابة حرس أو لأسباب أخرى، ومنهم أبو قتادة الأنصاري. انظر القسم 4.2: قصة أبي قتادة
4. الانطلاق نحو مكة: أحداث ومواقف في الطريق
4.1. تخلف بعض الأعراب وتثبيطهم
خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الميقات ومعه حوالي 1400 من أصحابه، بينهم أربع نساء فقط: زوجه أم سلمة رضي الله عنها، وأم عمارة نسيبة بنت كعب (التي دافعت ببسالة عن النبي في أُحد)، وأم منيع، وأم عامر رضي الله عنهن. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمامه عشرين فارساً كطليعة استكشافية.
في طريقه إلى مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنفر الأعراب من القبائل المحيطة بالمدينة ويدعوهم للخروج معه للعمرة. لكن الكثير منهم تخوفوا وترددوا، بل وحاولوا تثبيط المسلمين. كانوا يرون أن ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى قريش، بعد كل ما كان بينهم من دماء وحروب، وهم غير مسلحين، هو انتحار مؤكد. قالوا: “لن يرجع محمد وأصحابه من سفرهم هذا أبداً”. تعللوا بأشغالهم وأموالهم وأهليهم، كما ذكر الله تعالى في سورة الفتح: “سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا” (الفتح: 11). لكن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الصادقين مضوا في طريقهم، لا يخشون في الله لومة لائم.
4.2. أحكام الصيد للمحرم وغير المحرم: قصة أبي قتادة والحمار الوحشي
من الأحداث الهامة التي وقعت في الطريق، والتي بينت بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيد للمحرم، قصة الصحابي الجليل أبي قتادة الأنصاري. كان أبو قتادة، كما ذكرنا، من القلة الذين لم يحرموا، ربما لكونه فارساً أو لحاجة أخرى.
يروي أبو قتادة أنه بينما كان المسلمون يسيرون، انقطعت نعله، فتوقف لإصلاحها ومعه بعض أصحابه المحرمين، بينما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما هو منشغل بإصلاح نعله، رأى أصحابه المحرمون حماراً وحشياً. لم يستطع المحرمون أن يشيروا إليه صراحة أو يعينوه على صيده، لأن ذلك يجعل الصيد حراماً عليهم، فالدلالة على الصيد أو الإعانة عليه من المحرم تجعله كأنه هو الذي صاد. لكنهم كانوا يتمنون لو أنه رآه ليصيده لهم.
بعد فترة، رفع أبو قتادة رأسه فرأى الحمار الوحشي. قام مسرعاً وركب فرسه، ولكنه نسي رمحه وسوطه. طلب من أصحابه المحرمين أن يناولوه إياهما، فرفضوا، قائلين: “لا والله لا نعينك عليه بشيء”، وذلك تورعاً منهم. نزل أبو قتادة بنفسه فأخذ رمحه وسوطه، ثم انطلق خلف الحمار الوحشي فاصطاده.
جاء بالحمار، فنزل الصحابة المحرمون يأكلون منه. ثم شك بعضهم في جواز ذلك، فتوقفوا عن الأكل. ولما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه عن الأمر. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: “هل معكم منه شيء؟” قال أبو قتادة: “نعم يا رسول الله، معي العضد”. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منها وهو محرم، ليُثبت لهم أن صيد الحلال (غير المحرم) للمحرم حلال، ما لم يصده المحرم لنفسه، أو يُصاد من أجله، أو يُعن عليه. هذه الحادثة، كما يسردها “أنس أكشن” بتفاصيلها، توضح جانباً من يسر الشريعة ودقتها.
4.3. بُسر بن سفيان يعود بأخبار استعدادات قريش
كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل بُسر بن سفيان الخزاعي (أو بُسر بن عمرو الخزاعي في بعض الروايات) من الميقات لياتي بأخبار قريش. وبينما المسلمون في طريقهم، عاد بُسر بوجه يملؤه الخوف والتوتر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشاً قد جمعت جموعها، واستنفرت الأحابيش (القبائل المتحالفة معها)، وخرجوا بلبسوا جلود النمور (كناية عن استعدادهم للقتال والموت)، وأخرجوا معهم النساء والأطفال (العُوذ المطافيل)، في إشارة إلى أنهم لن يتراجعوا وسيقاتلون حتى النهاية. وعاهدوا الله ألا يدخل محمد مكة عليهم أبداً إلا عنوة (بالقوة).
كان خالد بن الوليد (ولم يكن قد أسلم بعد) على رأس قوة من فرسان قريش تقدر بمائتي فارس في “كُراع الغميم” (موضع قرب عسفان) لملاقاة المسلمين ومنعهم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم عند سماعه هذا الخبر: “يا ويح قريش! لقد أكلتهم الحرب. ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب؟ فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فما تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله، أو تنفرد هذه السالفة (يعني تنقطع رقبته ويموت)”. الرجوع إلى مشاورة الصحابة
5. المواجهة الأولية والتفكير الاستراتيجي النبوي
5.1. مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه
بعد ورود أخبار استعدادات قريش العدائية، جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وشاورهم كعادته. هل يميلون على ذراري المشركين الذين استنفرتهم قريش وتركوا أهليهم؟ أم يمضون لما خرجوا له (العمرة)، ومن اعترضهم قاتلوه؟
قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه، كعادته في المواقف الصعبة، وقال: “يا رسول الله، والله لو تسير بنا وراء مكة لسرنا معك، رقابنا أمامك، امض لما أراك الله فنحن معك”. وتكلم آخرون بمثل هذا.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى تجنب القتال ما أمكن، فهو لم يخرج لقتال، وإنما خرج معتمراً معظماً للبيت الحرام، وساق معه الهدي. قال: “إنا لم نخرج لقتال أحد، ولكنا خرجنا عماراً (معتمرين)”.
5.2. سلوك طريق ذات الحنظل الوعر
عندما اقتربت خيل المشركين بقيادة خالد بن الوليد من المسلمين، وكانوا قد رأوا سوادهم (جمعهم الكبير)، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف. ثم، ولكي يتجنب الاصطدام المباشر مع قوات خالد، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلك طريقاً آخر غير مألوف، طريقاً وعراً وصعباً يعرف بـ “ذات الحنظل” أو “ثنية المُرار”، يؤدي إلى أسفل مكة وينتهي بالحديبية.
سأل النبي صلى الله عليه وسلم: “من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟” فقام رجل من بني أسلم (يذكر الراوي أنه صحابي لم يسمه، ولكن الروايات تشير إليه) وقال: “أنا يا رسول الله”. فسلك بهم هذا الطريق الوعر. ارتفع الغبار من مسير الجيش الإسلامي، فرأته قريش، وظنوا أن المسلمين يسيرون في طريقهم المعتاد، فانطلقوا بسرعة ليسبقوهم إليه. لكن المسلمين كانوا قد غيروا مسارهم.
عندما وصلوا إلى مرتفع في هذا الطريق (ثنية الحنظلة أو المرار)، قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يجوز هذه الثنية أحد إلا غفر الله له”. فتسابق المسلمون لاجتيازها، وغفر الله لهم جميعاً إلا رجلاً واحداً تخلّف يبحث عن ناقة له ضلت، وقال: “لأَنْ ألقى ناقتي خير لي من أن يغفر لي”، فمات وراء ناقته ولم ينل هذه المغفرة.
5.3. معجزة إعماء أبصار قريش عن نيران المسلمين
بعد أن اجتازوا هذا الطريق الصعب، وصل المسلمون إلى مكان أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعلوا فيه النيران ويعدوا الطعام، فقد كانوا جائعين ومتعبين. تخوف بعض الصحابة من أن ترى قريش نيرانهم وهم قريبون من مكة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم طمأنهم قائلاً: “إنهم لن يروكم، إن الله سيعمي أبصارهم عنكم”. وبالفعل، كما يروي الصحابة، أشعلوا أكثر من خمسمائة نار، ولم ترهم قريش، مع أنهم كانوا يطوفون حولهم يبحثون عنهم، وكانت الدنيا ظلاماً دامساً (بداية الشهر القمري، الهلال صغير). وهذه من المعجزات التي أكرم الله بها نبيه وأصحابه.
6. الوصول إلى الحديبية: معجزات وأحداث مفصلية
6.1. “حبسها حابس الفيل”: توقف ناقة النبي القصواء
واصل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته المسير حتى وصلوا إلى منطقة الحديبية (مكان قرب مكة، بعضه في الحل وبعضه في الحرم). وعند مرتفع معين، بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء فجأة ورفضت التقدم. حاول الصحابة جاهدين أن يجعلوها تقوم، فما قامت، وكأنها ترى شيئاً يمنعها. ظن بعضهم أنها “خلأت” (حرنت أو تعبت)، لكن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يعرف طبيعة ناقته، قال: “ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخُلُق، ولكن حبسها حابس الفيل”. الرجوع إلى قصة أبرهة والفيل
هذه إشارة واضحة إلى أن توقف الناقة لم يكن أمراً عادياً، بل هو بتدبير إلهي، كما حُبس فيل أبرهة عن التقدم نحو الكعبة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: “والذي نفسي بيده، لا يسألوني اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها”. هذا القول يكشف عن نية النبي صلى الله عليه وسلم في تجنب القتال واحترام حرمة مكة، واستعداده لقبول شروط قد تبدو صعبة، طالما أنها تعظم حرمات الله.
6.2. معجزة تكثير الماء من البئر الجافة
أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنزول في الحديبية. لكن المكان كان قليل الماء، به بعض الآبار شبه الجافة، لا تكفي لسقاية هذا العدد الكبير من الناس (1400 رجل) ودوابهم. اشتكى الصحابة من العطش. وهنا تجلت معجزة أخرى من معجزات النبوة.
دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدلو فيه قليل من الماء، فتوضأ منه ومضمض، ثم أمر ناجية بن جُنْدُب الأسلمي (سائق بدن النبي) أن يصب هذا الماء في إحدى الآبار الجافة (أو قليلة الماء)، وأن يضع فيها سهماً من كنانته ويحرك الماء به.
فما أن فعل ناجية ذلك، حتى بدأ الماء يفور ويتزايد في البئر بغزارة، حتى فاض وملأ المكان. فكبّر الصحابة وهللوا وشربوا وسقوا دوابهم وارتووا جميعاً. أما المنافقون، الذين كانوا بين صفوف المسلمين، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، فقد حاولوا التقليل من شأن هذه المعجزة، زاعمين أنها عين ماء انفجرت بالصدفة. لكن المؤمنين ازدادوا إيماناً ويقيناً.
6.3. نزول المطر: رحمة وتثبيت وحديث الإيمان والكفر بالكواكب
بعد معجزة الماء، أنزل الله عليهم مطراً غزيراً كان رحمة وتثبيتاً لهم. استبشر به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، واعتبروه علامة على رضا الله وتأييده. لكن المنافقين، كعادتهم، قالوا: “هذا مطر الخريف، لا شيء غريب فيه”.
في صباح اليوم التالي، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الصبح ثم قال لهم: “أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟” قالوا: “الله ورسوله أعلم”. قال: “قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مُطِرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مُطِرنا بنَوْء كذا وكذا (أي بسبب نجم كذا أو كذا، كما كانت عادة أهل الجاهلية)، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب”. هذا الحديث يقطع الشك باليقين في مسألة نسبة الأحداث الكونية إلى الأسباب المباشرة دون ردها إلى مسبب الأسباب، الله سبحانه وتعالى، وهو تحذير لمن ينسبون الأمور إلى الأبراج والنجوم.
6.4. خطبة النبي تحت الشجرة والمغيرة بن شعبة حارساً
خيم المسلمون في الحديبية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس تحت شجرة كبيرة هناك (قيل إنها شجرة سَمُر). أمر بتنظيف ما تحتها، ثم جمع الصحابة وخطب فيهم خطبة بليغة، ذكرهم فيها بأهمية التمسك بكتاب الله وسنته، قائلاً حديثه المشهور: “تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي”.
في هذه الأثناء، كان الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه، وهو رجل ضخم قوي البنية، يقف حارساً للنبي صلى الله عليه وسلم، مدججاً بالسلاح ومغطى بالحديد حتى وجهه، لا يكاد يُعرف. كان المغيرة غير محرم، وذلك ليتمكن من الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقتضى الأمر، فالنبي كان محرماً ولا يحمل سلاحاً.
7. سلسلة المفاوضات والرسل بين المسلمين وقريش
بدأت قريش، بعد أن علمت بمكان المسلمين في الحديبية، بإرسال الرسل للتفاوض والتحقق من نواياهم.
7.1. بُديل بن ورقاء الخزاعي: ناصح أمين
أول من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان بُديل بن ورقاء الخزاعي، وهو من رجال خزاعة، وكانت خزاعة حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم (عيبة نصح له). جاء بديل ومعه نفر من قومه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريشاً مصممة على منعه من دخول مكة بالقوة. حاول بديل أن يكون محايداً أو ناصحاً، لكنه ربما تكلم بشيء من الفوقية أو التقليل من شأن قوة المسلمين، قائلاً ما معناه: “ما أرى معك أحداً له وجه، وجوهكم ليست وجوه قتال”. فغضب أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورد عليه رداً قوياً (يذكر الراوي أنه قال له “امصص بظر اللات” وهي عبارة قاسية تعني كف عن هذا الكلام السخيف، لكننا نورد المعنى الأقرب وهو “كل تراباً” أو “اسكت ولا تتفوه بالهراء”).
هدأ النبي صلى الله عليه وسلم الموقف، وأخبر بديل أنه لم يأت لقتال، وإنما جاء معتمراً معظماً للبيت. رجع بديل إلى قريش وأخبرهم بما رأى وسمع، وأن محمداً لا يريد حرباً، وأنهم رأوا الهدي معهم. لكن قريشاً اتهمته بالانحياز لمحمد، ولم يأبهوا لنصيحته، وقالوا: “وإن كان جاء لا يريد قتالاً، فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبداً، ولا تحدث العرب بذلك عنا”.
7.2. مِكرز بن حفص: رسول الغدر
ثم أرسلت قريش مِكرز بن حفص (أحد بني عامر بن لؤي). فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلاً، قال: “هذا رجل غادر (أو فاجر)”. تكلم مكرز مع النبي صلى الله عليه وسلم بنفس منطق قريش، محاولاً تخويفه ودفعه للرجوع. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما أجاب به بديل. فرجع مكرز إلى قريش ولم يتوصلوا إلى نتيجة.
7.3. الحُليس بن علقمة سيد الأحابيش: شهادة حق
بعد ذلك، قررت قريش أن ترسل الحُليس بن علقمة الكناني، وكان سيد الأحابيش (مجموعة قبائل متحالفة مع قريش، وكانوا يعظمون البيت الحرام). ظنت قريش أن الحليس، لكونه من أهل البادية والمعظمين للشعائر، قد يؤثر على محمد أو يقتنع بمنطق قريش.
فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحليس مقبلاً، قال لأصحابه: “هذا من قوم يتألهون (يعظمون الآلهة والشعائر الدينية)، فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه”. ففعلوا، واستقبله الصحابة بالتلبية.
ما أن رأى الحليس الهدي يساق أمامه، وقد قلّد وأشعر، والناس يلبون، حتى أدرك أن هؤلاء القوم ما جاؤوا إلا للعمرة وتعظيم البيت. لم يصل حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل رجع من مكانه إلى قريش وقال لهم بغضب: “يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم، ولا على هذا عاقدناكم! أيُصَدُّ عن بيت الله من جاءه معظماً له؟ والذي نفس الحليس بيده، لَتُخَلُّنَّ بين محمد وما جاء له، أو لأنفِرَنَّ بالأحابيش نفرة رجل واحد”. حاولت قريش تهدئته، قائلين: “مَهْلاً يا حليس، كُفَّ عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به”. لكنه أصر على موقفه، فانكسرت شوكة قريش قليلاً بهذا الموقف.
7.4. عروة بن مسعود الثقفي: انبهار بقائد وأتباعه
بعد موقف الحليس، تشاورت قريش فيما بينها، وقرروا إرسال رجل داهية له وزنه ومكانته، وهو عروة بن مسعود الثقفي (عم الصحابي المغيرة بن شعبة، ولم يكن قد أسلم بعد). جاء عروة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس يتحدث معه. حاول عروة أن يثني النبي صلى الله عليه وسلم عن عزمه، وأن يخوفه من قريش، وأن يقلل من شأن أصحابه قائلاً إنهم “أوباش” (خليط من الناس) سيفرون عنه عند أول شدة.
فغضب أبو بكر الصديق وقال له كلمته الشهيرة: “أنحن نفر عنه وندعه؟ امصص بظر اللات!” (وهي شتيمة قاسية كانت معروفة عندهم).
أثناء حديثه، كان عروة يمد يده ليلمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عادة عندهم في الكلام لإظهار الود أو الاستعطاف. وكلما مد يده، كان المغيرة بن شعبة (ابن أخ عروة)، الواقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم مقنعاً بالحديد، يضرب يده بقائم السيف ويقول: “أخِّر يدك عن لحية رسول الله قبل ألا تصل إليك!”. استغرب عروة وتساءل: “من هذا؟” فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: “هذا ابن أخيك، المغيرة بن شعبة”. فقال عروة للمغيرة: “أي غُدَر (يا غدار)! ألستُ أسعى في ديتك؟” (كان المغيرة قد قتل قوماً وغدر بهم قبل إسلامه، وكان عروة يسعى في دفع ديتهم).
7.4.1. وصف عروة لتعظيم الصحابة للنبي
الأهم من الحوار، هو ما لاحظه عروة من سلوك الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يرمقهم بنظرات فاحصة. فلما رجع إلى قريش، قال لهم كلاماً خالداً يصور مدى حب وتعظيم الصحابة لنبيهم:
“يا معشر قريش، إني قد جئت كسرى في ملكه، وقيصر في ملكه، والنجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت مَلِكاً في قوم قط مثل محمد في أصحابه. والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه (الماء المتبقي من وضوئه). وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يُحِدُّون إليه النظر تعظيماً له. ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبداً. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها”.
هذا الوصف الدقيق كان له أثر كبير، فهو شهادة من رجل غير مسلم، له خبرة بالملوك والأكاسرة، تؤكد أن العلاقة بين محمد وأصحابه ليست علاقة حاكم بمحكومين، بل هي علاقة نبي مرسل بأتباع مؤمنين، يفتدونه بأرواحهم وأنفسهم.
7.5. خِراش بن أمية الخزاعي ومحاولة قتله
بعد ذلك، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل رسولاً آخر إلى قريش ليؤكد لهم أنه لم يأت للحرب. فدعا خِراش بن أمية الخزاعي، وأعطاه جملاً من جماله اسمه “الثعلب” ليركبه إلى مكة. فلما دخل خراش مكة، عرفت قريش جمل النبي صلى الله عليه وسلم، فعقروا الجمل (قتلوه)، وكادوا يقتلون خراشاً نفسه. لولا أن الأحابيش منعوهم ودافعوا عنه، لقتلوه. فرجع خراش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث، فزاد ذلك من غضب المسلمين.
7.6. عثمان بن عفان سفيراً إلى مكة
عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إصرار قريش على العدوان، أراد أن يرسل رجلاً له منعة وقوة في قريش. فدعا عمر بن الخطاب ليرسله. اعتذر عمر، وقال: “يا رسول الله، إني أخاف قريشاً على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها. ولكني أدلك على رجل أعز بها مني: عثمان بن عفان”.
كان عثمان رضي الله عنه من بني أمية، وله عشيرة قوية في مكة، وكان محبوباً وله مكانة. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، وأرسله إلى أبي سفيان وإلى زعماء قريش ليخبرهم أن المسلمين لم يأتوا لحرب، وإنما جاؤوا زواراً لهذا البيت ومعظمين لحرمته.
انطلق عثمان إلى مكة. وفي الطريق لقيه أبان بن سعيد بن العاص الأموي (ابن عمه)، فأجاره وحمله على فرسه حتى دخل مكة. بلغ عثمان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى زعماء قريش. فقالوا له: “إن شئت أن تطوف بالبيت فطف”. فقال عثمان قولته الشهيرة: “ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم”.
احتبست قريش عثمان عندها، وطال غيابه، فانتشرت بين المسلمين إشاعة قوية بأنه قد قُتل.
8. بيعة الرضوان: عهد على الموت تحت الشجرة
8.1. إشاعة مقتل عثمان ووقعها على المسلمين
عندما شاع خبر مقتل عثمان بن عفان (وهو رسول وله حصانة)، كان وقع ذلك شديداً على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. كان هذا يعني أن قريشاً قد اختارت الحرب والصدام، وأنها مستعدة لانتهاك كل الأعراف بقتل الرسل. لم يكن الخبر مؤكداً، لكنه كان كافياً لإشعال الموقف.
8.2. الدعوة للبيعة وتدافع الصحابة
عندئذ، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى البيعة تحت الشجرة (التي كان يجلس تحتها). دعاهم إلى البيعة على الموت، أو على ألا يفروا. فتهافت الصحابة يبايعونه، يصافحونه واحداً تلو الآخر، مؤكدين ولاءهم واستعدادهم للتضحية. كان عمر بن الخطاب من أوائل المبايعين، وكان يمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم من الأسفل ليسنده، لكثرة من يصافحه، حتى لا يتعب النبي صلى الله عليه وسلم من مد يده لمبايعة 1400 رجل.
بايع جميع الصحابة الحاضرين إلا رجلاً واحداً من المنافقين اسمه الجَدّ بن قيس، الذي اختبأ تحت بطن جمله حتى لا يراه أحد، خوفاً وجبناً.
أما عن عثمان، فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى يديه على الأخرى وقال: “هذه عن عثمان” (أو “هذه يد عثمان”)، فكانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان كبيعة عثمان نفسه، بل أفضل.
8.3. قصة سلمة بن الأكوع وبيعاته الثلاث
من المواقف البارزة في هذه البيعة، قصة الصحابي الشجاع سلمة بن الأكوع الأسلمي، الذي كان معروفاً بسرعته الفائقة (يقال إنه كان يسبق الخيل عدواً) وقوته. يروي سلمة أنه بايعه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في ذلك اليوم.
يقول سلمة: “بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس، قال: يا سلمة، ما لك لا تبايع؟ قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال: وأيضاً. فبايعته الثانية”. ثم رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة (وقيل إن النبي رآه أعزلاً، أو أن عم سلمة كان أعزلاً فأعطاه سلمة درعاً كان النبي قد أعطاها لسلمة)، فقال له: “يا سلمة، ألا تبايع؟” قال: “يا رسول الله، قد بايعتك في أول الناس وأوسطهم”. قال: “وأيضاً”. فبايعه الثالثة. ثم سأله النبي عن درعه، فأخبره أنه أعطاها لعمه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه البيعات المتكررة لسلمة، كما يوضح “أنس أكشن”، كانت لرفع معنويات الصحابة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم انظروا إلى شجاعة سلمة واستعداده.
8.4. فضل أهل بيعة الرضوان
هذه البيعة سميت “بيعة الرضوان”، لأن الله تعالى رضي عن أصحابها. قال تعالى في سورة الفتح: “لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا” (الفتح: 18). وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة”. وهذا فضل عظيم ومكانة رفيعة لأهل هذه البيعة.
9. قدوم سهيل بن عمرو وشروط الصلح المجحفة
بعد هذه البيعة التي أظهرت تصميم المسلمين على القتال إذا لزم الأمر، تبين أن خبر مقتل عثمان كان إشاعة، وأن عثمان لا يزال حياً محبوساً لدى قريش. وهنا، بدأت قريش تشعر بالخطر الحقيقي، وأن محمداً وأصحابه لن يتراجعوا بسهولة. فأرسلت قريش رجلها المفاوض الداهية، سهيل بن عمرو.
فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهيلاً مقبلاً، قال: “لقد سهُل لكم من أمركم” (أو “قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل”).
9.1. شروط الصلح وبنوده القاسية
بدأ سهيل بن عمرو مفاوضاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متشدداً جداً في شروطه، محاولاً أن يحصل لقريش على أكبر قدر من المكاسب الظاهرية. دارت مفاوضات طويلة وعسيرة، انتهت بالاتفاق على صلح لمدة عشر سنوات، تضع الحرب أوزارها بين الطرفين. ولكن بنود الصلح كانت في ظاهرها مجحفة جداً بحق المسلمين، ومثيرة لغضبهم وحزنهم. من أهم هذه البنود:
- عودة المسلمين هذا العام: أن يرجع المسلمون هذا العام فلا يدخلوا مكة، ويعودوا في العام القادم فيقيموا بمكة ثلاثة أيام فقط، معهم سلاح الراكب (السيوف في القُرُب)، ولا يخرج معهم من أهل مكة أحد.
- رد من جاء مسلماً من قريش: أن من أتى محمداً من قريش مسلماً بغير إذن وليه (هارباً منهم)، رده عليهم.
- عدم رد من جاء مرتداً من المسلمين: أن من جاء قريشاً ممن مع محمد (مرتداً عن الإسلام)، لم يردوه عليه.
- حرية التحالف للقبائل: أن من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. (فدخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش).
هذه الشروط، وخاصة الشرطين الثاني والثالث، كانت قاسية جداً على نفوس الصحابة. كيف يردون مسلماً جاءهم فاراً بدينه، ولا تسترد قريش من ارتد ولحق بها؟ لقد شعروا بالظلم والإهانة. وكما يصف “أنس أكشن”، كانت قلوبهم “تتقطع” و”دماغهم يغلي” من الغيظ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الشروط بوحي من الله.
9.2. كتابة وثيقة الصلح والخلاف حول الألفاظ
دعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليكتب وثيقة الصلح.
9.2.1. رفض “بسم الله الرحمن الرحيم”
أملى النبي صلى الله عليه وسلم على علي: “اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم”.
فقال سهيل بن عمرو: “أما الرحمن، فوالله ما أدري ما هو. ولكن اكتب: باسمك اللهم، كما كنت تكتب”.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: “اكتب: باسمك اللهم”. ففعل علي.
كان هذا أول تنازل شكلي، ولكنه كان صعباً على المسلمين الذين اعتادوا بدء أمورهم بالبسملة الكاملة.
9.2.2. رفض “محمد رسول الله” وموقف علي بن أبي طالب
ثم أملى النبي صلى الله عليه وسلم: “هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو”.
فقال سهيل: “والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. ولكن اكتب: محمد بن عبد الله”.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: “اكتب: محمد بن عبد الله”.
هنا، رفض علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بمحبته العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرته على مكانته، أن يمحو كلمة “رسول الله” بيده. قال: “والله لا أمحوها أبداً”.
كان الموقف متوتراً. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي (وكان النبي أمياً لا يقرأ ولا يكتب): “أرني مكانها”. فأشار له علي إلى موضع كلمة “رسول الله”، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، ثم قال لعلي: “اكتب: محمد بن عبد الله”.
هذا الموقف يظهر مدى صعوبة الأمر على الصحابة، وفي نفس الوقت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وصبره، واستعداده للتنازل عن أمور شكلية في سبيل تحقيق هدف أسمى وهو الصلح وحقن الدماء، طالما أن ذلك بوحي من الله.
10. أزمة أبي جندل بن سهيل: امتحان الصبر والإيمان
10.1. ظهور أبي جندل واستغاثته بالمسلمين
بينما كان الصلح يوشك أن يُختم، وقبل أن يجف مداد الكتاب، وقع حدث زاد من ألم المسلمين وغيظهم إلى أقصى حد. فجأة، ظهر أبو جندل بن سهيل بن عمرو (ابن المفاوض القرشي سهيل)، وهو يرسف في قيوده (يسحبها بصعوبة)، وقد هرب من مكة وجاء إلى المسلمين مستجيراً ومستغيثاً. كان أبو جندل قد أسلم وعُذّب في مكة وحُبس بسبب إسلامه.
فلما رآه أبوه سهيل بن عمرو، قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلابيبه وجره بعنف، وقال: “يا محمد، قد لجّت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا” (أي أن الاتفاق قد تم، ويجب أن تسلمه لي بموجب شروط الصلح التي تنص على رد من جاءك من قريش مسلماً).
قال النبي صلى الله عليه وسلم: “صدقت”.
10.2. موقف النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته لأبي جندل
بدأ أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: “يا معشر المسلمين، أأُردُّ إلى المشركين يفتنونني في ديني؟”
كان منظره مؤثراً ومفجعاً. قلوب الصحابة تتمزق، وهم يرون أخاهم في الإسلام يُجر أمامهم ليعاد إلى العذاب، ولا يستطيعون فعل شيء التزاماً بالعهد.
التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي جندل وقال له كلاماً يفيض حكمة وصبراً وتثبيتاً: “يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً، وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله، وإنا لا نغدر بهم”.
10.3. غضب عمر بن الخطاب ومحاولته
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكاد ينفجر من الغيظ. فقام يمشي إلى جانب أبي جندل وهو يُجر، ويقرب منه قائم سيفه، ويقول له بصوت خفيض: “اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب”. كان عمر يرجو أن يأخذ أبو جندل السيف فيضرب به أباه، ولكن أبا جندل لم يفعل، ربما خوفاً أو احتراماً لوالده رغم شركه، أو إدراكاً منه لخطورة الموقف.
كان هذا الموقف من أصعب المواقف التي مرت بالمسلمين، وهو امتحان عظيم لإيمانهم وصبرهم وطاعتهم لله ولرسوله. وكما يقول “أنس أكشن”، “كادوا يهلكون من قوة الحزن والزعل والغيظ”.
11. ما بعد توقيع الصلح: غضب الصحابة وحكمة أم سلمة
11.1. حوار عمر بن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم
بعد توقيع الصلح ومشهد أبي جندل، لم يستطع عمر بن الخطاب أن يكتم ما في نفسه من ألم وغضب. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له:
“يا رسول الله، ألستَ نبي الله حقاً؟” قال: “بلى”.
قال عمر: “ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟” قال: “بلى”.
قال عمر: “فَلِمَ نُعطِي الدَّنِيَّة في ديننا إذاً؟” (الدنية: الأمر الحقير أو المذل).
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته المعهودة: “إني رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصري”.
لم يقتنع عمر تماماً، فذهب إلى أبي بكر الصديق وقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم. فأجابه أبو بكر بنفس جواب النبي، وزاد: “يا عمر، الزم غرزه (اتبع أمره ولا تخالفه)، فإني أشهد أنه رسول الله”. فقال عمر: “وأنا أشهد أنه رسول الله”. لكن قلبه كان لا يزال ممتلئاً بالأسى.
11.2. تردد الصحابة في النحر والحلق
بعد إبرام الصلح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقوموا فينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم، تحللاً من إحرامهم، لأنهم قد صُدوا عن البيت ولن يعتمروا هذا العام.
ولكن، لشدة ما بهم من الحزن والهم والذهول، لم يقم أحد منهم! كرر النبي صلى الله عليه وسلم أمره ثلاث مرات، وما من مجيب. كانوا كالمصعوقين، لا يصدقون أن أحلامهم بدخول مكة والطواف بالبيت قد تبخرت، وأنهم سيعودون دون أن يحققوا ما خرجوا من أجله، بل وبشروط يرونها مذلة.
11.3. مشورة أم سلمة رضي الله عنها وفعل النبي
دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته أم سلمة رضي الله عنها مغضباً وحزيناً من عدم استجابة الصحابة لأمره. فأشارت عليه أم سلمة بمشورة حكيمة تدل على رجاحة عقلها وفقهها. قالت: “يا نبي الله، أتحب ذلك (أن يطيعوك)؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة، حتى تنحر بُدْنَك (إبلك)، وتدعو حالقك فيحلقك”.
فهمت أم سلمة أن الصحابة في حالة صدمة، وأنهم بحاجة إلى قدوة عملية تقطع شكهم وتجعلهم أمام الأمر الواقع.
أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة أم سلمة. فخرج ولم يكلم أحداً، ونحر هديه بيده، ثم دعا حالقه (خراش بن أمية أو معمر بن عبد الله) فحلق رأسه.
11.4. نحر جمل أبي جهل: رسالة رمزية
فلما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، أيقنوا أن الأمر قد قُضي ولا رجعة فيه. فقاموا مسرعين إلى هديهم فنحروه، وجعل بعضهم يحلق لبعض، حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً من شدة الغم والغيظ والحنق، كما يصف الراوي. كانوا يحلقون بعنف، والدماء تسيل على وجوههم، في مشهد يعكس عمق الألم الذي كانوا يشعرون به.
يذكر “أنس أكشن” أن من بين الهدي الذي نحره النبي صلى الله عليه وسلم كان جمل أبي جهل، الذي غنمه المسلمون في بدر. وكان أهل مكة يعرفون هذا الجمل جيداً. فنحره النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم كان رسالة رمزية قوية، تذكرهم بهزائمهم الماضية وتزيد من غيظهم، وفي نفس الوقت ترفع من معنويات المسلمين قليلاً.
12. أحداث متفرقة بعد الصلح وقبل العودة
بعد الصلح، سمح المشركون للمسلمين بالدخول إلى منطقة الحديبية، فاختلط الناس بعضهم ببعض. وبدأ بعض سفهاء المشركين يستفزون المسلمين بالكلام الجارح والسب، والمسلمون صابرون التزاماً بالصلح.
12.1. مقتل ابن زنيم وتصرف سلمة بن الأكوع الشجاع
في هذه الأثناء، وقع حادث كاد أن يفسد الصلح. قام أربعة من المشركين (يذكر الراوي أنهم كانوا غير منضبطين وناوين على الشر) بقتل رجل من المسلمين اسمه ابن زنيم (أو ابن رنيم).
كان سلمة بن الأكوع، البطل المقدام، جالساً تحت شجرة، وقد كنّس ما تحتها. فجاء هؤلاء الأربعة وجلسوا تحتها بوقاحة، وعلّقوا أسلحتهم، وأخذوا يتكلمون عن قتلهم لابن زنيم ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم.
لم يتحمل سلمة، فقام بهدوء إلى شجرة أخرى. لكن عندما سمع صراحة بقتلهم لابن زنيم، لم يتمالك نفسه. وبسرعته الخارقة، انقضّ عليهم وانتزع أسلحتهم المعلقة بيد واحدة، وقال لهم: “والذي كرم وجه محمد، لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت عنقه!”.
12.2. شجاعة عامر بن الأكوع وأسره لتسعين مشركاً
أمسك سلمة بهؤلاء الأربعة. وفي نفس الوقت، انتشر خبر مقتل ابن زنيم، فظن بعض المشركين أن الصلح قد نُقض، وبدأوا يتجمعون ويستعدون للقتال. وهنا برزت شجاعة أخرى من عائلة الأكوع، وهو عامر بن الأكوع (عم سلمة، أو أخوه في بعض الروايات). كان عامر أيضاً سريعاً وقوياً. انطلق وحده فكتّف حوالي سبعين أو تسعين رجلاً من المشركين الذين كانوا قد تجمعوا بنية الشر، وساقهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر “أنس أكشن” قصة غريبة عن إسلام عامر، وهي أن ذئباً كلمه في الصحراء وأخبره ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم!
12.3. عفو النبي صلى الله عليه وسلم ونبوءته بغدرهم المستقبلي
لما جيء بهؤلاء الأسرى (الأربعة الذين قتلوا ابن زنيم، والسبعين أو التسعين الذين جمعهم عامر) إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي موقف يدل على عظيم حلمه ورغبته في الحفاظ على الصلح، أمر بإطلاق سراحهم جميعاً! وقال عنهم: “دعوهم، يكن لهم بدء الفجور وثناؤه” (أي يكون لهم أول الغدر وآخره). وهذه نبوءة بأن هؤلاء القوم (أو قريش بشكل عام) سيغدرون وينقضون العهد مرة أخرى، وهو ما حدث فعلاً وكان سبباً في فتح مكة لاحقاً.
13. العودة إلى المدينة وتنزّل سورة الفتح
13.1. تساؤلات الصحابة حول الرؤيا النبوية
بعد ثلاثة أيام قضاها المسلمون في الحديبية، تجهزوا للعودة إلى المدينة، وقلوبهم مثقلة بالحزن والهم. كانوا قد خرجوا وأملهم يحدوهم بدخول مكة وأداء العمرة، وربما فتح مكة، وها هم يعودون دون تحقيق شيء من ذلك ظاهرياً.
في طريق العودة، سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم (أو دار هذا التساؤل في نفوسهم بقوة): “يا رسول الله، ألم تقل لنا أنك ستدخل مكة آمناً وتطوف بالبيت؟” كانت الرؤيا النبوية لا تزال عالقة في أذهانهم، وكأن هناك تعارضاً بين الرؤيا والواقع.
13.2. نزول سورة الفتح: بشرى وتثبيت
فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه: “بلى، ولكن هل قلت لكم أنه سيكون في عامنا هذا؟” قالوا: “لا”. فقال: “فهو كما قال لي جبريل عليه السلام” (أو “فهو كائن”).
وبينما هم في الطريق، أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم سورة الفتح بكاملها، وفيها البشرى العظيمة:
“إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا * لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا * وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا” (الفتح: 1-3).
وقال تعالى أيضاً: “وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا” (الفتح: 20).
فرح النبي صلى الله عليه وسلم بنزول هذه السورة فرحاً شديداً، وقال: “لقد أُنزلت عليَّ الليلة سورة، لهي أحب إليَّ مما طلعت عليه الشمس”.
كانت هذه السورة بمثابة البلسم الشافي لجراح الصحابة، والتفسير الإلهي لما حدث. فالله تعالى سمّى صلح الحديبية “فتحاً مبيناً”. وأخبرهم أن هذا الصلح، رغم مرارته الظاهرية، هو في حقيقته نصر وتمهيد لانتصارات ومغانم كثيرة قادمة، أولها غزوة خيبر التي أشار إليها الراوي في نهاية حديثه. فتحسنت نفسيات الصحابة كثيراً، وأدركوا أن كل ما حدث كان خيراً وتدبيراً إلهياً حكيماً.
14. الدروس والعبر المستفادة من صلح الحديبية
صلح الحديبية مدرسة مليئة بالدروس والعبر، نوجز أهمها:
- أهمية الطاعة والانقياد لأمر الله ورسوله: حتى لو بدا الأمر مخالفاً للمنطق أو للمصلحة الظاهرية، فإن الخير كل الخير في طاعة الله ورسوله. صبر الصحابة على الشروط المجحفة، رغم ألمهم، كان طاعة للنبي الذي يتلقى الوحي.
- النظرة الاستراتيجية بعيدة المدى: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما هو أبعد من المكاسب الآنية. الصلح أوقف الحرب، وأتاح الفرصة للدعوة الإسلامية أن تنتشر، وأن يدخل الناس في دين الله أفواجاً، وهذا ما حدث فعلاً. عدد المسلمين الذين أسلموا في السنتين التاليتين للصلح (حتى فتح مكة) فاق عدد من أسلموا طوال تسعة عشر عاماً قبله.
- فقه الواقع والمرونة في التعامل مع الأحداث: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم جامداً، بل كان يتخذ القرارات بناءً على الواقع والمعطيات، مع الحفاظ على الثوابت. قبوله للصلح بشروطه كان من هذا الباب.
- أهمية الشورى: استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في مختلف المراحل، وحتى أخذه بمشورة زوجته أم سلمة، يؤكد أهمية هذا المبدأ في الإسلام.
- الثقة المطلقة في وعد الله ونصره: رغم كل الصعوبات، كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الصادقون على يقين بنصر الله، وأن العاقبة للمتقين.
- مكانة الصحابة وتضحياتهم: أظهرت أحداث الحديبية مدى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، واستعدادهم للتضحية بكل شيء في سبيل الله ورسوله، كما تجلى في بيعة الرضوان.
- الحكمة الإلهية في تقدير الأمور: ما قد يبدو شراً أو هزيمة في الظاهر، قد يكون خيراً ونصراً في حقيقته وباطنه. “وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ” (البقرة: 216).
15. خاتمة: الحديبية فتح مبين وخطوة نحو النصر الأكبر
لم يكن صلح الحديبية نهاية المطاف، بل كان بداية مرحلة جديدة وحاسمة في تاريخ الدعوة. لقد كان بحق “فتحاً مبيناً” أدى إلى اعتراف قريش بالدولة الإسلامية كقوة ندية، وأتاح للمسلمين حرية الحركة والدعوة، وأضعف الجبهة الداخلية لقريش، ومهد الطريق لغزوة خيبر (التي غنم منها المسلمون مغانم كثيرة كما وعدهم الله)، ثم في نهاية المطاف إلى فتح مكة الأعظم بعد سنتين فقط من هذا الصلح، عندما نقضت قريش العهد.
إن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أحداث مثل صلح الحديبية، تمنحنا زاداً لا ينضب من الحكمة والإيمان والبصيرة، وتعيننا على فهم سنن الله في الكون وفي قيادة الأمم والمجتمعات.